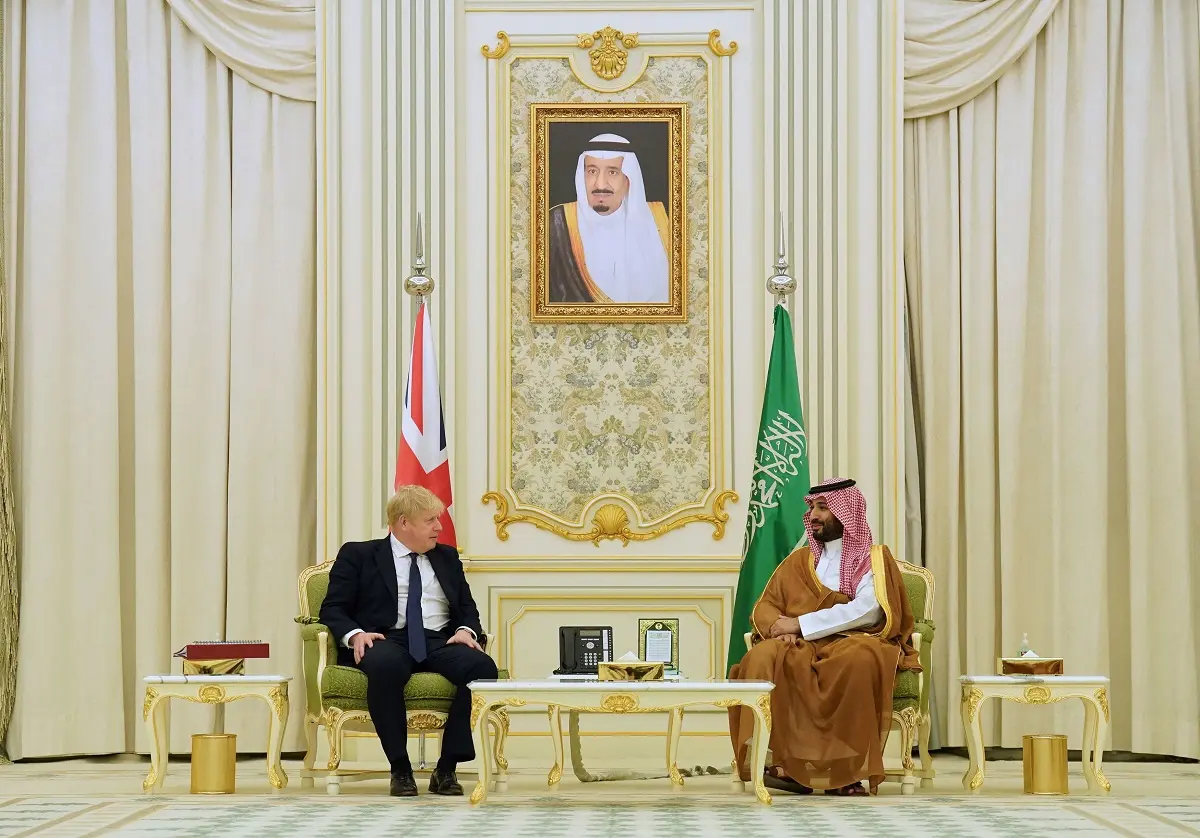الجزيرة برس / اسلام ويب/ أ.د. عبد الكريم بكار/لو عدنا إلى أدبياتنا عبر القرون الماضية لوجدنا أن معظم تنظيرنا للشؤون الثقافية كان ينصب عليها بوصفها علومًا واختصاصات معرفية منظمة.
وربما سادت تلك النظرة بسبب قلة ما في أيدينا من المعارف والمعطيات المتعلقة بالإنسان باعتباره كائنًا متعدد الجوانب ومتعدد الاحتياجات.
أما اليوم فإن المفهوم (الأنثروبولوجي) للثقافة آخذ في الانتشار والرسوخ، حيث إن هناك اعتقادًا متزايدًا بمحدودية تأثير (العلم المجرد) في صياغة السلوك الإنساني وفي توجيه حركة الحياة اليومية.
الثقافة كما بلورها علماء الإنسان هي ذلك النسيج المكوَّن من العقائد والمفاهيم والنظم والعادات والتقاليد وطرز الحياة السائدة في بقعة محددة من الأرض.
إنها طريقة عيش شعب بعينه، أو هي ما يجعل الحياة جديرة بالعيش.
إن تنوع العناصر المكوّنة للثقافة يمنحها قوة هائلة في مواجهة الوافدات الأجنبية وما يمكن أن تتعرض له من ضغوطات داخلية. إنه حين يتعرض أحد أنساق الثقافة للهجوم أو الوهن، فإنها تعتمد في استمرارها واستعادة حيويتها على باقي أنساقها، لكن نقطة قوة الثقافة هذه هي أيضًا نقطة ضعفها حيث يعرضها تنوع مكوناتها في أحيان كثيرة إلى ما يشبه الانقسام على الذات بسبب التصادم بين بعض أنساقها؛ وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى ما سميناه “إدارة الثقافة”.
وأود هنا أن أدلي بالملاحظتين الآتيتين في هذه القضية: في كل مجتمع نوعان من الثقافة: ثقافة عليا وثقافة شعبية أو ثقافة نخبة وثقافة جماهيرية.
الثقافة العليا تتكون بطريقة واعية وتكون أكثر دراية ببنيتها العميقة؛ وذلك لأننا نتملكها عن طريق القراءة والتأمل والحوار الرفيع والمقارنة وطرح الأسئلة.
أما الثقافة الشعبية فإنها ليست كذلك، إنها تتكون بطريقة غير واعية وغير مقصودة، حيث يتشربها أبناء المجتمع ويتشبعون بها كما يتنفسون الهواء.
ونقطة ضعفها هذه هي نقطة قوتها، حيث إن اختراقها من قبل الثقافات الأجنبية يكون عسيرًا بسبب عشوائيتها وكتامتها ورقابة المجتمع المشددة عليها. أما الثقافة العليا التي نبدأ بنشرها منذ الصف الأول الابتدائي إلى ما لا نهاية فهي الثقافة التي تمثل الأمة أمام الأمم الأخرى، وهذا ما يجعلها على درجة حسنة من المرونة والقدرة على التكيف ، وتمثل الرموز الثقافية الأجنبية، أي أن كثيرًا من الاقتباس والتطوير يأتي عن طريقها .
إلا أن تنظيمها وتمثيلها الخارجي لثقافة الأمة يعرضها لأمرين مزعجين: الأول سهولة اختراقها؛ حيث إن طريقة اكتسابها الواعية تفتح الطريق لغزوها وبالتالي تحويرها وتهجينها.
الثاني: جفول الوعي الشعبي من أصحابها والشعور بأنهم يتجاوزون حدودهم إلى درجة يسوغ معها اتهامهم بخيانة الأمة وبيعها للغرباء.
ومع أن شيئًا من هذا ينطبق فعلاً على بعض المثقفين إلا أن المشكلة أن الثقافة الشعبية لا تملك المعايير المنهجية ولا الأسس المنطقية التي تمكنها من الحكم الراشد على تصرفات النخبة، مما يجعل موقفها شاعريًا أكثر من أن يكون عقلانيًا. وهي بدافع من الخوف من الانقطاع تلجأ في كسب قضيتها إلى التيارات النخبوية الأكثر محافظة وتقليدية لتقدم لها العون في كبح اندفاع التيارات المتحررة والمتطلعة إلى التحديث.
وهذا يجعل من الثقافة الشعبية عاملاً مهمًا في زيادة الانقسام بين تيارات الثقافة العليا ؛ يمكن القول: إن تطوير الثقافة الشعبية وتخليصها من العادات والسلوكيات الخاطئة يقع على عاتق الصفوة أصحاب الثقافة العليا، لكن من الصعب أن يحصلوا على الاستجابة لمناشداتهم وطروحاتهم ما داموا موضع شك وريبة من أولئك الذين يحتاجون إلى خدماتهم.
في العالم الإسلامي قامت الثقافات الوطنية والمحلية منذ أمد بعيد بإفراغ طاقاتها على الحضّ والكفّ في الثقافة الإسلامية المستندة إلى الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء، وصار من غير الممكن المضي قدمًا في تطوير أي شأن محلي بعيدًا عن مدلولات هذه الثقافة ورمزياتها وتحديداتها.
وهذا يعني أن ثقافة النخبة لا تستطيع أن تصبح قوة محركة للناس ما لم تتشرب روح الدين وما لم تلتزم بقطعياته وأطره العامة. إننا في مرحلة حرجة يحتاج فيها كل من يروم الإصلاح إلى ولاء الناس وحماستهم وتضحياتهم؛ لأن المفكر لا يملك أكثر من ناصية التنظير؛ والجماهير التي ستتحمل عبء التنفيذ؛ ولهذا فلابد من الاستحواذ على رضاها وإعجابها.
وستكون النخبة في وهم كبير إذا ظنت أنها تستطيع إحداث تغييرات كبرى من غير مساندة حقيقية من طيف واسع من أبناء الأمة. وقد أثبتت التجارب الكثيرة الإسلامية وغير الإسلامية أن كل حمل يتم خارج رحم الأمة هو أشبه بالحمل الكاذب. وحين يجافي أهل الرؤية والخبرة روح الدين فإنهم يُسلمون زمام الأمة إلى عناصر تملك الكثير من الحماسة والاندفاع والقليل من البصيرة والفهم لمتطلبات المرحلة.
إن طاقة ثقافة الأمة تكمن في المستوى الشعبي منها، على حين أن عقلها ورشدها في المستوى الصفوي. وهذا التفاوت هو دائمًا مصدر للتوتر والنزاع، لكن في الوقت نفسه يمكن أن يكون مصدرًا للتطوير نحو الأحسن والأقوم إذا أدرنا العلاقة بينهما بما هو مطلوب من الذكاء والوعي.
إن تنوع الأنساق المكوّنة للثقافة يحيل دائمًا على إمكانية حدوث الصدام والنزاع، كما هو الشأن في التنوع والتعدد. ويبدو أن أشد أنواع التوتر تلك التي تقع بين الثقافة بوصفها (هوية) وسمات خاصة بالأمة والثقافة بوصفها تعبيرات عن نزعات استهلاكية أو تعبيرات عن تحركات لتلبية حاجات الجسد أو تعبيرات عن التكيف مع ظروف ومعطيات شديدة القسوة.
وكلما أوغل الناس في مدارج الحضارة اشتد الصراع بين هذين النسقين من أنساق الثقافة؛ ذلك لأن ثقافة (الهوية) تتسم بالتعالي عن الانشغال بالواقع، وتنزع نحو المطلق.
على حين أن التحضر يزيد وعي الناس نحو مصالحهم، ويفتح شهيتهم على الاستهلاك، مما يفضي في نهاية المطاف إلى تضخم الثقافة المتعلقة بتسيير الحياة اليومية وتحقيق المنافع الشخصية، وهذا يجعل الناس يشعرون ويظهرون بأنهم أكثر دنيوية، وهو ما يثير حساسية الترميزات العميقة للهوية في الثقافة الإسلامية.
من الواضح اليوم أن ثقافة (ما بعد الحداثة) تشجع على انبعاث (الهويات) في كل أنحاء العالم من خلال عمل غير مقصود، وهو المناداة بالنسبية الثقافية وتأكيد انعدام الأطر والمرجعيات وجعل (الحقيقة) شيئًا تابعًا للثقافة.
وتكمّل (العولمة) المهمة حين تعتمد (نظام التجارة) أداة أساسية في (تسليع) كثير من مظاهر الحياة وجعلها أمورًا جاهزة للمتاجرة والمساومة.
إن هذا الدفق الهائل من الرموز والصور الاستهلاكية يساعد على نحو استثنائي على انتشار الهويات المقاتلة دفاعًا عن الوجود قد لا يكون أمامنا لإدارة الصراع المحتدم في عمق الثقافة على هذا الصعيد إلا أن ندعم الأنشطة الروحية والأدبية والاجتماعية ذات النفع العام، وأن نحاول إضفاء المعنى على الأنشطة الدنيوية من خلال الحرص على شرعيتها وشرح ما يمكن أن يجعلها موصولة بالأعمال الأخروية.
وما لم نفعل ذلك فإننا سنعاني من الانقسام والتمزق في أعماق ثقافتنا، وسنشعر بتشتت الجذور وضياع الأهداف الكبرى.