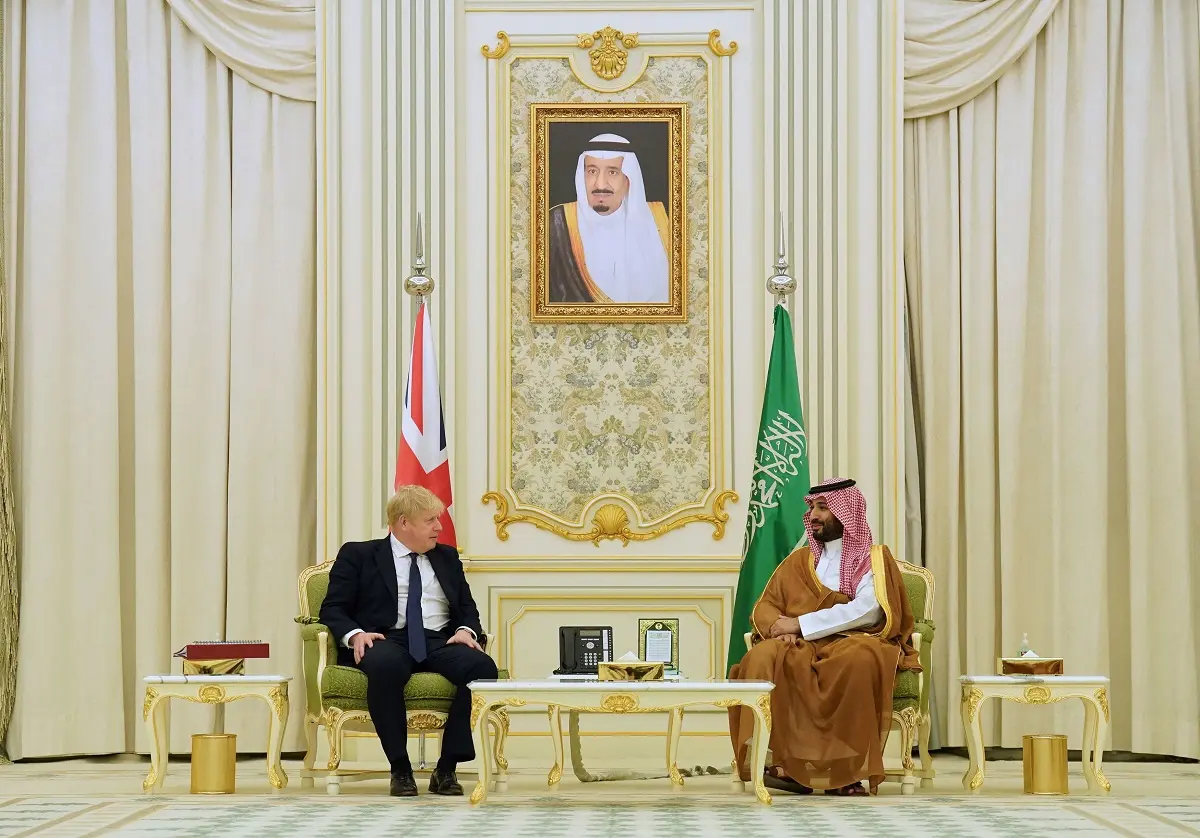لم يعد سرّاً، ولا كشفاً، إعجاب باراك أوباما بريتشارد نيكسون في «فتحه» الصين عام 1972. فغير مرّة، وبلسانه، عبّر الرئيس «الديموقراطيّ» و»المثاليّ» عن إعجابه بسلفه «الجمهوريّ» و«الواقعيّ» حين طبّع مع الدولة الشيوعيّة الأكبر في العالم. يومذاك كان التناقض السوفياتيّ – الصينيّ مصدر الإغراء الأكبر لواشنطن كي تمضي في «ديبلوماسيّة البينغ بونغ»، خصوصاً أنّ الحرب الحدوديّة بين العملاقين الشيوعيّين في 1969 كانت قد فتحت الأبواب لتوسيع هذا التناقض. ومنذ ذلك الحين راح يتعاظم الخوف المزمن من الصين لدى حلفاء الولايات المتّحدة الآسيويّين، وعلى رأسهم اليابان التي ربّما كانت تَهمّ أميركا وتعنيها أكثر ممّا يهمّها أيّ بلد آخر في العالم.
فهل يمكن القول، استطراداً، أنّ تلك السابقة النيكسونيّة – الصينيّة مصدر استلهام لأوباما في علاقته بإيران؟
إذا صحّت هذه الفرضيّة، صحّ أنّ أوباما يضع «داعش» وعموم «الإرهاب السنّيّ» حيث كان نيكسون يضع الاتّحاد السوفياتيّ، كما جاز الكلام على فرضيّة المسارات المتعدّدة في السياسة الخارجيّة لأميركا. فمن جهة، هناك صلة مفتوحة مع الصين وإيران تدور حول قضايا بعينها، ومن جهة أخرى، هناك خلافات ثابتة معهما تدور حول القضايا الأخرى المستبعَدة من الاتّفاق، ومن جهة ثالثة، هناك الضمانات والتطمينات لحلفاء أميركا، في الشرق الأقصى والشرق الأوسط، ومفادها ردع الصين وإيران عن تهديد الحلفاء المذكورين. وأخيراً، ربّما قام رهان على تحوّلات داخليّة في الصين وإيران، وهو ما لم تكذّبه الصين: فالرأسماليّة، بقيادة دينغ هسياو بنغ، انطلقت مع المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعيّ في 1978. ولئن لم يتغيّر حكم الحزب الواحد، إلاّ أنّ الحزب الواحد تغيّر، فبات، مثلاً لا حصراً، يتّسع لرجال الأعمال. ومن ناحية أخرى، ومع تصدّع المعسكر الاشتراكيّ، انفجرت الصين في ساحة تيان آن مين وكانت المواجهة الدمويّة الشهيرة. وربّما رأى أوباما أنّ شيئاً من هذا الحراك تنطوي عليه إيران: صحيح أنّ انتخاباتها لا تجمعها بالانتخابات إلاّ صلة شكليّة، بيد أنّها ذات مرّة أتت بمحمّد خاتمي رئيساً، ثمّ جدّدت له. ودولةٌ تترجّح رئاستها بين خاتمي وأحمدي نجاد تُغري بتوقّع الاحتمالات الخصبة فيها. كذلك أمكن، في 2009، أن تظهر «الثورة الخضراء»، السلميّة والمدنيّة، التي سُحقت من غير أن تُسحق الكتلة التي تجهر بحبّ الثقافة الأميركيّة، وهذا علماً أنّ اثنين كانا من عتاة الخمينيّين، مير حسين موسويّ ومهدي كرّوبي، قادا الثورة المذكورة.
على نطاق أعرض، لم يكن القلق الذي أثاره التطبيع الأميركيّ – الصينيّ لدى بقية الآسيويّين الخبر الوحيد عنهم. فقد شهدت الثمانينات ولادة «التنانين الأربعة»، تايوان وكوريا الجنوبيّة وسنغافورة وهونغ كونغ (التي أعيدت لاحقاً، في 1997، إلى البرّ الصينيّ). وما لبثت آسيا، وفي غمار الثورة الصناعيّة الثالثة، أن فرزت ظاهرة «النمور الآسيويّة» الأربعة، إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وتايلندا. ولئن ارتبط معظم التحوّل الاقتصاديّ الباهر لهذه البلدان بنُظم ديكتاتوريّة ومستبدّة، إلاّ أنّ أواخر الثمانينات ما لبثت أن أطلقت سيرورة من التحوّل نحو الديموقراطيّة السياسيّة فيها.
وقد جاءت نهاية الحرب الباردة وظهور أجندة الديموقراطيّة والمجتمع المدنيّ ليمنحا ثقلاً إضافيّاً لسياسة المجتمعات، بدل الاقتصار على سياسات السلطات وحدها. لكنّ العالم العربيّ الذي استغرقته حرب العراق و»الحرب على الإرهاب» لم يجد لديه كماليّات الإنصات إلى هذا الجديد، ولم يكن متحمّساً أصلاً للإنصات، فبقي التشكيك بحقوق الإنسان ومنظّماتها وجمعيّاتها أقرب إلى رياضة وطنيّة يجتمع فيها الحاكم وكثيرون من المحكومين. وبهذا فاقمنا نقص الجاذبيّة لدينا، فأضفنا إلى حسّ المسؤوليّة الضعيف رغبتنا الصريحة في منع المجتمعات من أن تتحرّك، ومن أن تكون لها سياساتها، بل من أن تكون هي نفسها مجتمعات.
فإذا كان أوباما قد أخطأ في التيمّن بنيكسون، وأخطأ في التفاهم مع إيران، فإنّ السلوك العربيّ، العادم للجاذبيّة والمسؤوليّة والحراك، كان حليفه الأوّل في ارتكابه.
*نقلاً عن “الحياة